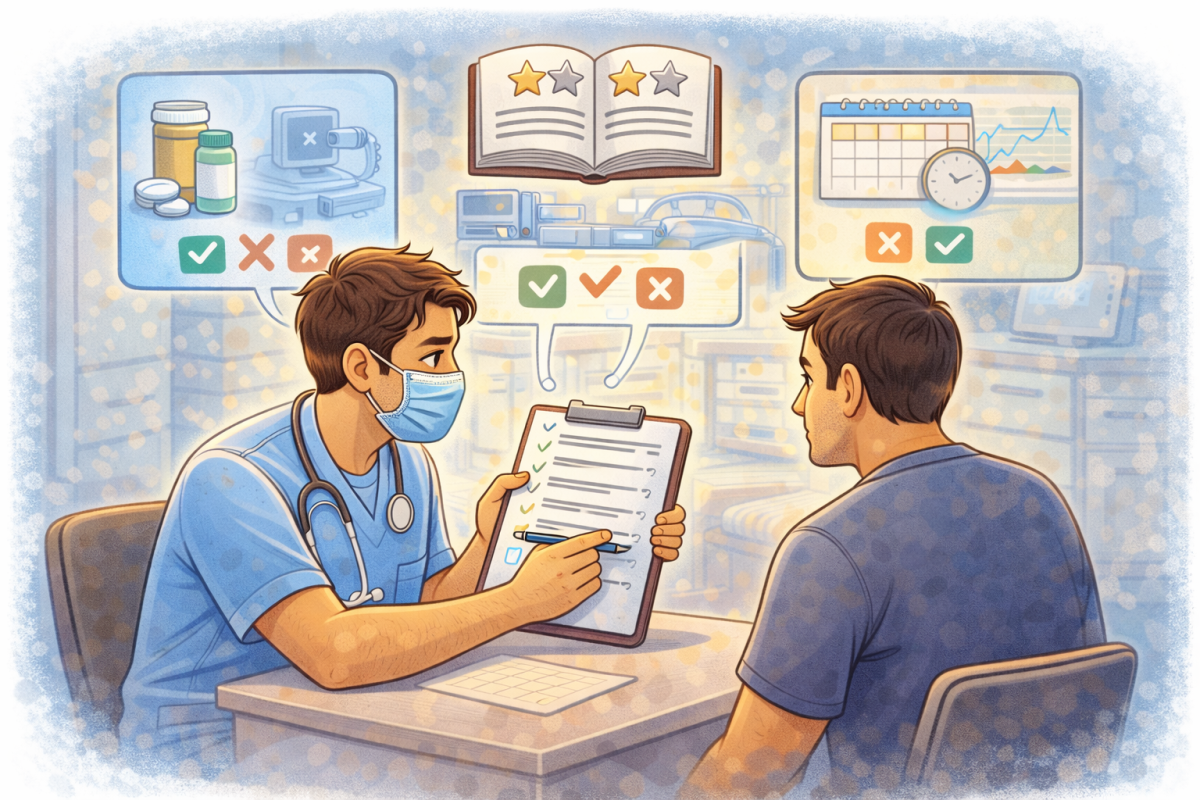لم يعد الطب اليوم مساحةً ضيقة تنحصر بين مريضٍ وطبيبٍ وتنتهي بوصفةٍ تُكتب أو إجراءٍ يُنفّذ. الرعاية الصحية الحديثة صارت منظومةً متكاملة: تقنياتٌ أدق، معاييرُ سلامةٍ أعلى، ملفاتٌ رقمية، متطلباتُ جودةٍ وتوثيق، ومسؤولياتٌ تنظيمية تتطلب أن يكون القرار الطبي واضحاً ومبرراً وقابلاً للتفسير. وهذا التحول لا ينتقص من إنسانية المهنة، بل يجعلها أكثر حاجةً إلى منهجٍ يحمي الحقوق ويقلل الالتباس ويرفع جودة التجربة العلاجية.
ومن هنا تظهر حساسية كلمة “التسويق” عند الحديث عن الطب. فالتسويق قد يُفهم كأنه محاولة لبيع صورةٍ أكثر من تقديم خدمة، بينما المعنى المهني المتزن أقرب إلى “التعريف المسؤول”: أن تصل الخدمة إلى من يحتاجها، وأن يفهم الناس ما الذي يُقدَّم لهم وما الذي لا يُقدَّم، وما الذي يمكن توقعه وما الذي لا يمكن ضمانه. الإشكال لا يبدأ من وجود التسويق، بل من انزلاقه إلى مبالغةٍ في الوعود، أو تبسيطٍ مخلّ للحقائق، أو خطابٍ يضغط على المراجع عبر الخوف بدل أن يخففه. هناك تتآكل الثقة، وهي أثمن ما في المهنة.
إذا كانت الثقة هي جوهر العلاقة العلاجية، فإن أقصر طريق إليها ليس الصخب ولا الإبهار، بل الوضوح. أندر ما يحتاجه الناس—وأعمق ما يصنع الفرق—هو طبيبٌ يستطيع تحويل التعقيد إلى فهمٍ مرتب. المراجع الذي يدخل العيادة قلقاً لا يبحث عن كلمات مطمئنة فقط، بل عن إجاباتٍ واضحة: ما الذي يحدث؟ لماذا؟ ما الخيارات المتاحة؟ ما الذي ترجّحه الأدلة لحالته؟ ما الفوائد المحتملة؟ ما المخاطر الممكنة؟ وما البدائل؟ ثم يحتاج أن يرى أن الخطة ليست قراراً عابراً، بل مسارٌ له مبررات وحدود وتوقعات واقعية.
ولهذا، فإن كثيراً من التوتر الذي يصاحب التجربة الطبية لا ينشأ من المرض وحده، بل من الغموض: توقعاتٌ تُبنى على عباراتٍ فضفاضة، أو تفاصيلٌ تُذكر بعد الإجراء لا قبله، أو نتائجٌ يُلمَّح إليها وكأنها مؤكدة بينما الواقع الطبي قائم على الاحتمالات والاختلافات الفردية. في المقابل، الطبيب الذي يشرح قبل أن يبدأ، ويضع حدوداً من البداية، ويقول “قد يفيد” بقدر ما يقول “قد لا يفيد”، ويُبيّن متى نحتاج التدخل ومتى يمكن الاكتفاء بالأقل—يعطي المراجع أرضاً صلبة يقف عليها. ومع التوثيق المهني لما تم شرحه والاتفاق عليه، تكتمل صورة الموافقة المستنيرة بوصفها احتراماً لحق الفهم والاختيار، لا مجرد إجراءٍ شكلي.
هنا تتشكل القيمة المهنية التي يظنها البعض “تسويقاً” وهي في حقيقتها نتيجة طبيعية للأثر. فالمراجع الذي يخرج وهو يفهم لماذا اختيرت الخطة، وكيف ستمضي، وما الذي سيُراقَب، ومتى نعيد التقييم—غالباً يشعر براحةٍ أكبر، ويصبح التزامه بالخطة أسهل، وقد تقل اتصالاته المرتبكة بعد الزيارة، ويقل احتمال سوء الفهم. ومع تكرر هذه التجربة، تتكون سمعةٌ هادئة لا تحتاج إلى ضجيج: ثقةٌ تُبنى لأن الناس ارتاحت للفهم، لا لأن الرسالة كانت الأعلى صوتاً.
ولا ينعكس أثر الوضوح على المراجع وحده، بل يمتد إلى جودة الخدمة نفسها. حين تكون الخطة مُعلَّلة ومكتوبة، يصبح مسار المتابعة أوضح، وتقل القرارات المتذبذبة، وتصبح التجربة أكثر اتساقاً بين أفراد الفريق. وفي بيئةٍ تُراجع فيها الجودة والسلامة بعناية، فإن المنهجية في الفحص والتفسير والقرار والتوثيق تُعد جزءاً من قوة الممارسة، لأن أثرها يظهر في التفاصيل العملية: وضوح المسار، انتظام المتابعة، وتوازن التوقعات.
أما الاستدامة المهنية—بمعناها الأوسع—فتقوم على تجنب المخاطر غير المحسوبة. ففي الرعاية الصحية، المخاطر لا تقتصر على النتائج السريرية؛ بل تشمل أيضاً سوء الفهم الذي قد يتحول إلى شكوى، أو وعدٍ مبالغ فيه يخلق توقعاً غير واقعي، أو نقصاً في الشرح يترك مساحةً للالتباس. لذلك فإن الطبيب الذي يلتزم بلغةٍ منضبطة، ويتجنب القطعيات غير الضرورية، ويعرض الخيارات بإنصاف، ويذكر الحدود كما يذكر الإمكانات—لا يقيّد النجاح، بل يحميه ويجعله أكثر ثباتاً مع الوقت.
وهكذا يلتقي الطب والتسويق من غير خصومة: التسويق الذي يليق بالطبيب ليس “إقناعاً بأي ثمن”، بل تعريفٌ صادقٌ وحدودٌ واضحة. أن يعرف الناس ما الذي يمكن تقديمه، ولمن يناسب، ومتى لا يناسب، وما المتوقع عادةً، وما الذي قد يختلف من شخصٍ لآخر، وما المخاطر الممكنة، وما البدائل المتاحة. قد يبدو هذا الخطاب أقل إبهاراً، لكنه غالباً أكثر إقناعاً على المدى الطويل؛ لأن الناس قد تنجذب إلى صورةٍ لوهلة، لكنها تثق وتلتزم مع تجربةٍ مفهومة.
في النهاية، “وقار الحكيم” ليس ترفاً لغوياً ولا تعالياً على السوق، بل هو ممارسةٌ يومية بسيطة في معناها عميقة في أثرها: أن تُقدّم الحقيقة قبل الانطباع، وأن تجعل الشرح جزءاً من العلاج، وأن يكون التوثيق احتراماً لا شكلاً، وأن تُعامل المراجع كإنسانٍ له حق الفهم والاختيار. وحين يصبح الوضوح هو العنوان، تتشكل قيمة الطبيب كما ينبغي: قيمةٌ تُرى في الاطمئنان، وفي الاستقرار، وفي الثقة التي تنمو بهدوء.